النخبة السياسية الأميركية، بما فيها قسمٌ واسعٌ من تلك «الجمهورية»، تريد التخلّص من ترامب بسرعة وبأقل الأكلاف. الهجوم من كلّ حدب وصوب يتركّز على الرجل ورغبته المجنونة بالبقاء في السلطة بأيّ ثمن. مايكل هيرش رأى في مقال على موقع «فورين بوليسي»، بعنوان «أصبحنا نعرف الآن ما يترتّب على رفض رئيس التنازل عن السلطة»، أنّ «التداول السلمي للسلطة كان ممكناً أساساً، ليس بسبب المبادئ المنصوص عليها في الدستور، بل بفضل الأشخاص الذين التزموا بها واحترموها... ترامب نرجسي مريض انتخبه الأميركيون، وظهرت صفاته الأسوأ بأكثر الطرق دراماتيكية خلال الأيام الأخيرة لرئاسته. فمن دون أدنى الإثباتات على وجود تزوير، هو أطلق حملة لنزع الشرعية عن الانتخابات، ودعا أنصاره إلى الاحتشاد في واشنطن».
ما يزيد من حنق الكتلة البيضاء هو شعورها بضمور نفوذها في مقابل غير الغربيين
لا
شك في أنّ جموح وانعدام توازن الرئيس الذي تشارف ولايته على الانتهاء قد
لعبا دوراً في تأجيج التناقضات السياسية الداخلية، وكذلك نقمة «أميركا
المهزومة»، لكنّ تناول هذا البعد حصراً في الخطاب السياسي والإعلامي السائد
يشي بإرادةٍ للتعامي عن الأبعاد الأخرى لما وقع في واشنطن، خصوصاً تلك
المتّصلة بقاعدته الموالية. حاز ترامب أصوات 74 مليون ناخب على رغم سلوكه
المشين والعلني، والهجوم الإعلامي - السياسي الذي لم يتوقّف ضده. السؤال
الجوهري الذي ينبغي أن يُطرح يتعلّق بهذه القاعدة الموالية الضخمة، التي
تضمّ مكوّنات وازنة باتت ترفض الإقرار بشرعية النظام السياسي الأميركي
ومؤسّساته المنتخبة، وتحضّ علناً على التمرّد عليه. مجموعات وتيارات يمينية
متطرّفة، كالميليشيات وأنصار تفوّق العرق الأبيض والجماعات الإنجيلية
المتشدّدة، ليسوا ظواهر جديدة في الولايات المتحدة. هم نمَوا باطراد مع
بداية التسعينيات، وتوسّع نفوذهم في الحزب الجمهوري منذ تلك الفترة، خلال
ما عرف بـ«الثورة المحافظة»، التي كان نيوت غينغريتش، النائب والمتحدّث
باسم مجلس النواب بين عام 1995 - 1999، أحد أبرز رموزها، واستمرّت في
الصعود مع ما سُمّي «حفلات الشاي»، في بداية الألفية الثانية. «ثورة
محافظة» أيديولوجية - ثقافية، مغرقة في الرجعية، انتشرت في أوساط أميركا
العميقة، داخل الحزب الجمهوري وخارجه، بالتزامن، وهذا هو اللافت، مع مسار
العولمة وما رافقه من سرديات عن «القرية العالمية» و«التبعية المتبادلة
والانفتاح»، و«نهاية التاريخ» والسيادة الأبدية لنموذج «ديموقراطية السوق».
هذا المسار، الذي قادته وتحكّمت فيه في بداياته الولايات المتحدة، والذي
ارتكز على ما سمّاه المؤرّخ البريطاني بول كينيدي «التوسّع الإمبراطوري
الزائد»، هو سبب الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية التي تفاقمت
في أميركا في العقود الماضية. استندت السياسات الاقتصادية والاجتماعية
النيوليبرالية الناجمة عن هذا المسار - الخيار، وما نتج عنها من تصفية
للخدمات الاجتماعية العامة ومن تحرير للرساميل وللتجارة ومن نقل للصناعات
نحو البلدان ذات اليد العاملة الرخيصة، إلى رهان النخب السياسية الأميركية
في الحزبين الرئيسيين، على قدرة بلادهم على توظيف العولمة لخدمة مصالحها
أولاً وتعظيم منافعها. غير أنّ الضمور المستمر في قدراتها على السيطرة،
الوثيق الصلة بحروبها الباهظة الأكلاف والفاشلة في تحقيق أهدافها، والأزمة
المالية والاقتصادية في عام 2008، في سياق تسارع صعود المنافسين على
المستويات الاقتصادية والاستراتيجية على صعيد عالمي، جميعها عوامل بنيوية
أسهمت في انحدار هيمنتها وتسعير تناقضاتها الداخلية. أميركا العميقة ترى
نفسها ضحية لعولمة خدمت مصالح «الآخرين»، بدءاً بنخب الساحلين، وصولاً إلى
الصين وجنوب شرق آسيا والهند وغيرها، على حسابها. وما يزيد من حنق هذه
الكتلة البيضاء الغاضبة، المشحونة بموروث العنصرية الأميركية المتجذّر
والأطروحات الجديدة المستلهمة منه، هو شعورها بضمور نفوذها في مقابل غير
الغربيين، بل واعتقادها أنّها قد تخضع لهيمنتهم في بلادها. من يلقي نظرة
على نظريات المؤامرة على الأميركيين «الأصليين» الشائعة في صفوف هذه
الكتلة، لن يفاجأ بحصول ما هو أكبر وأعنف ممّا تمّ في الكونغرس. ولا ريب في
أنّ تضافر الانقسامات السياسية، وتلك العرقية، الداخلية مع تلك الخارجية،
المتمثّلة أولاً في احتدام «التنافس بين القوى العظمى»، سيفاقم من هشاشة
الديموقراطية الإمبراطورية في السنوات المقبلة، ومن انحسار نفوذها المحتوم.







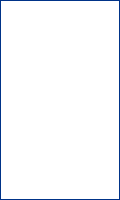









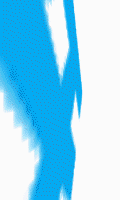
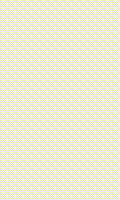

.gif)

